قراءة نفسية في جذور الإيمان واللاإيمان وأسباب ...التطرّف!
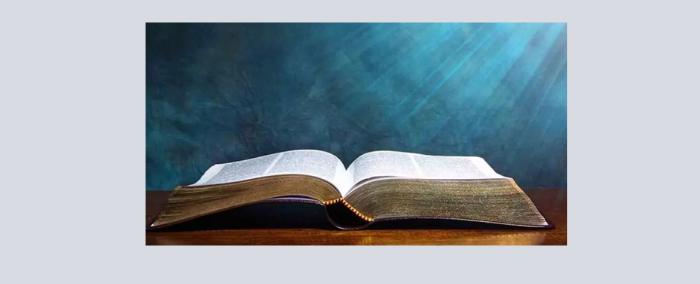
شكّل الدين، منذ آلاف السنين، جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان في مختلف المجتمعات والثقافات، تمامًا كما كان الإلحاد واللا إيمان حاضرين في تجارب بشرية أخرى. لكن لماذا نجد أن بعض الأشخاص متدينون جدًا، بينما البعض الآخر يتوزع بين مكتف بإيمان معتدل، أو عدم الإيمان كليا؟ ولماذا تبدو بعض المجتمعات شديدة التديّن كبولندا أو الولايات المتحدة، في حين أن مجتمعات أخرى مثل فرنسا أو بلجيكا تتسم بقدر كبير من العلمانية؟ وهل الإيمان مجرد خيار شخصي يخضع لحتميات نفسية واجتماعية تتحكّم بسلوك الإنسان؟ أم له علاقة باختلاف الذكاء بين شخص وآخر، أو بتوجهاته السياسية، أو ميوله الفنية…؟
يتطلّب تطوّر الأديان وانتشارها في المجتمعات، مقاربة متعددة التخصصات، قد تتخطّى المنظور النفسي، من هنا لجأ الباحثون إلى الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ، وذلك لتقديم إضاءة تساهم في فهم أعمق للإنسان، سواء كان مؤمنًا أو غير مؤمن، انطلاقًا من العوامل الاجتماعية والعائلية، وحتى البيولوجية، التي تلعب دورًا في تشكيل توجهاته الدينية أو غيابها.
على عكس ما يُعتقد أحيانًا، لا يُعد الانتماء الديني، أو ممارسة الشعائر الدينية، أو تعريف الشخص لنفسه كمؤمن خيارًا حرًا تمامًا من منظور إحصائي، بل هو امتداد لما اكتسبه من تنشئة اجتماعية محمّلة بالمعتقدات، والعواطف، والقيم التي ترسّخت فيه منذ الطفولة، إذ غالبًا ما يعيد إنتاج هذا “الإرث العاطفي والعقلي” الذي نشأ عليه.
وعمومًا، يميل الأشخاص إلى الحفاظ على منظومة قيمهم ومعتقداتهم الدينية طوال حياتهم، ونادرًا ما تحدث تحولات جذرية في هذا المجال. وحتى عندما تحدث تغييرات، فإنها عادة ما تكون نتيجة لتجارب حياتية استثنائية، مثل الأزمات العاطفية، أو فقدان عزيز، أو النجاة من موت محتّم، أو لقائهم بشخص غيّر مجرى حياتهم… فنراهم إما يكرّسون حياتهم لمساعدة الآخرين، أو حتى إذا “كفروا بالله”، لا يلبثون أن يعودوا إلى إيمانهم بعد فترة وجيزة.
لا شك أن التربية و”التنشئة الدينية”، إلى جانب بعض التجارب الحياتية، تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الإيمان أو غيابه لدى الأفراد، إلا أن هذا الدور، رغم أهميته، ليس كافيًا وحده لتفسير سبب تباين مستويات الإيمان أو اللا إيمان بين أشخاص ينتمون إلى المجتمع نفسه.
السمات والاستعدادات
من منظور علم نفس الشخصي، من الطبيعي أن نتساءل عمّا إذا كان الانتماء الديني مرتبطًا ببعض السمات أو الاستعدادات الأساسية التي تُشكّل جوهر الفرد. فهل توجد خصائص شخصية، قد تكون فطرية إلى حد ما، تجعل بعض الأشخاص أكثر قابلية للإيمان، بينما تعيق هذه القابلية الآخرين؟
أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص المؤمنين يختلفون عن غير المؤمنين من حيث السلوكيات والمواقف، كترتيب القيم واختيار المهن وأنماط الحياة المرتبطة بالجنس، والعائلة والأنشطة الترفيهية وحتى في طبيعة حس الفكاهة لديهم… فعلى سبيل المثال، يميل المؤمنون إلى إعطاء أهمية أكبر للقيم التي تدعم النظام الشخصي والاجتماعي، مثل الوفاء، والطاعة، والصدق، بينما يُنظر إلى الاستقلالية والمتع الفردية كأمور أقل أهمية، كما أنهم ينجذبون غالبًا إلى المهن ذات الطابع الاجتماعي أو الخيري أو التربوي، ويميلون إلى اتباع أنماط أقل تنوعًا في العلاقات والممارسات الجنسية، (لكنها ليست بالضرورة أقل إرضاءً).
أما في ما يتعلق بالفكاهة، يشير الباحثون إلى أن الأشخاص المؤمنين أقل ميلاً لاستخدام الفكاهة العدوانية أو المبتذلة، ويميلون عمومًا إلى استخدام الفكاهة بدرجة أقل، خاصة في المواقف التي تنطوي على نوع من التقييم، مثل الخضوع للاختبارات المخبرية.
سيماهم في وجوههم
كشفت دراستان حديثتان عن نتائج مفاجئة: الأولى أجراها ريتشارد ويسمان من جامعة هيرتفوردشاير، والثانية لورا ناومان وزملاؤها من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. في كلتا الدراستين، طُلب من المشاركين النظر إلى صور لأشخاص مختلفين لتحديد ما إذا كانوا مؤمنين أم لا. والمثير للده�شة أن المشاركين نجحوا، إلى حد كبير، في معرفة الانتماءات الدينية لهؤلاء الأشخاص.
ورجّح الباحثان أن يكون ذلك بسبب وجود اختلافات جوهرية في سمات الشخصية بين المؤمنين وغير المؤمنين، وهي اختلافات قد تنعكس على ملامح الوجه أو أنماط السلوك، وقد حددها الباحثون بخمسة وهي: الود، الانضباط، المرونة الذهنية، الانفتاح الاجتماعي والتوتر.
الودّ: يظهر المؤمن سمات شخصية تتعلق بالود والانضباط بنسبة ٦٠٪ مقابل ٤٠٪ لغير المؤمن، أما في ما يتعلّق بمساعدة الآخرين تبيّن أن ٧٠٪ من المؤمنين يميلون إلى مساعدة الآخرين شرط أن يكونوا مقربين منهم.
الانضباط: بيّنت الدراسة أن المؤمن أكثر قدرة على التحكّم بنفسه والالتزام بالقواعد والقدرة على تأجيل المتعة الفورية وكبح الرغبات والمحافظة على القيم.
وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين يتمتعون بسمتي الود والانضباط في الطفولة والمراهقة يكونون أكثر ميلًا إلى التديّن في مراحل لاحقة من حياتهم. ومع البلوغ، قد يقل تأثير البيئة، ويظل الشخص متمسّكًا بمعتقداته الدينية، في حين
يختار آخرون بدائل غير دينية.
المرونة الذهنية: رأت الدراسة أنّ الأشخاص الذين يتمتعون بانفتاح عقلي منخفض مع درجات مرتفعة في الود والانضباط يميلون إلى الانخرا�ط في الحركات الأصولية التي ترفض الأفكار الجديدة.
الانفتاح الاجتماعي: على نقيض الانفتاح العقلي المنخفض، إنّ الأشخاص الذين يتمتعون بالانفتاح الاجتماعي، غالبًا ما نراهم يميلون نحو الروحانية.
التوتر: لاحظت الدراسة أنّ الأشخاص المتوترين غالبًا ما نراهم قلقين، فيرون الله كقاضٍ قاسٍ بلا رحمة.
وعليه يمكن القول، بأن الإنسانية من خلال توارث الأفكار وتبادلها ونشرها، سواء كان في كتب أو طقوس دينية أو دنيوية، ساهمت في تنوّع المعتقدات والتقاليد، وفي حين تقبّلها البعض لأنه رأى فيها تناغمًا مع بنيته النفسية، رفضها آخرون للسبب عينه.

